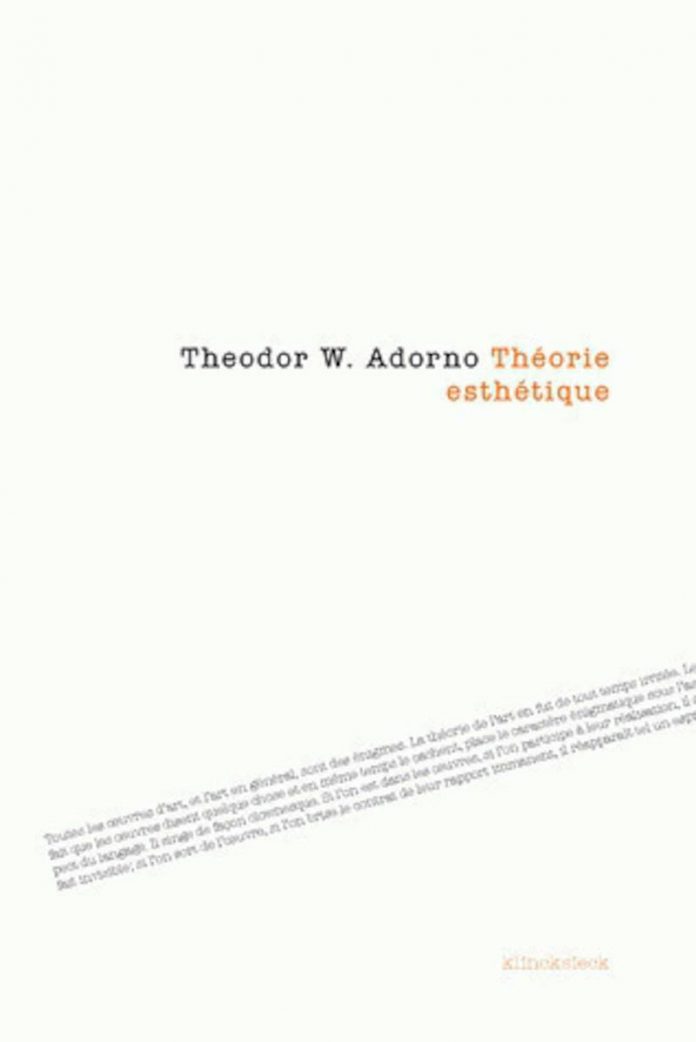ليس ثمّة ما يدعو إلى ضرورة الاحتفاء بالنّاقد المسرحيّ. على الأرجح، ثمّة حاجة إلى إزاحته. وبتطرّف أقلّ، ثمّة من يشتهي موته بالتأكيد على غيابه أو بالدفع إلى ضرورة تأبينه. أمّا أن نتساءل عن القتلة، فهذا ما يتطلب بالضرورة نقد الرّاهن الإبداعي للمنجز المسرحيّ ذاته، أو لنقل إنّه ثمّة هوّة كبيرة بينهما، بقدر ما استبعدت النّاقد عمدت إلى زجّ الفنّ المسرحيّ في تخوم جمالية وفكرية جديدة يمكن القول بأنّها ورّطته هو الآخر نحو سياسات حتفه، لا لشيء إلّا لأنّه يقاد إليها عن جهل من قبل المتكلمين باسمه.
إنّ ما يدعو إليه المبدع المسرحيّ اليوم، نتيجة وقوعه طريدة سهلة في طور “صناعة الثقافة” بعبارة أدورنو ووعيه السلبي بمقولة “أفول هالة الفن” بعبارة بنيامين، هو معاملة الناقد كما لو أنّه بوق دعاية لأعماله، ولذلك فهو يحاول في كلّ مرّة الإجهاز عليه بطرق مختلفة، بعد أن صار يحتكم إلى بدائل جديدة في التسويق إلى أعماله دون أدنى تصحيح نقدي أو نظري، ما أعطى مشروعيّة استنبات الانحطاط المسرحيّ والإعلان عن عزاء ميتافيزيقيّ كان النّاقد قربانه.
ربّما يصحّ الحديث -أمام عدميّة الرّاهن في أزمنة سرديات الموت- وحالة “النزاع اللاانساني” بعبارة ليوتار، عن موت الناقد المسرحي مثلما مات قرينه المؤلّف مع “رولان بارت”، ومثلما مات الإله مع نيتشه ومثلما اندثرت الميتافيزيقا مع هيدجر ومثلما توقّف التاريخ مع فوكوياما ومثلما اندثر الإنسان مع فوكو، ولكن التسليم بذلك لن يفضي إلا إلى نوع من السّبي المعرفي داخل معادلة الرّاهن عينه، لذلك صار يتوجّب البحث عن ثقب مّا داخل تلك المعادلة، القائلة بفكرة النهايات، منه يبدأ التفكير من جديد، وهي مهمّة قد تحرّض الفلاسفة على التدخّل في شؤوننا الحياتية والثقافية والمسرحيّة من جديد، حتّى إذا ما فعلت ذلك صار ممكنا التنبّؤ بمولد “الناقد الأخير”، ذلك الرّؤيوي الذي تكون من مهمّاته زراعة المستقبل.
لتحصين هذا الإشكال، سنحاول في هذه الورقة الاشارة إلى تلك المرتكزات والسياقات العلمية والفكرية والجمالية التي أنتجت مقولة موت النّاقد أو كيف حوّلته إلى عدوّ المسرح بعد أن اتّخذ المسرح ذاته منعطفات جديدة ، ومن ثمّ التساؤل فلسفيا عن كيف يمكن تقويض سردية النهايات وأفول الفنّ بما يؤهّل لمولد النّاقد الأخير، ذلك النبيّ الذي لا يشتبك مع المنجز المسرحيّ بقدر ما يقرأه تأويليا في إطار تمعينه للعالم.
1- عن كيف مات النّاقد
يبدو النّاقد، في سياق هذه “الملّة” المنتمية إلى حقول المسرح، قربانا بائسا، منبوذا وغريبا، كما لو أنّه شخص نابتة بكلّ ما تحمله هذه العبارة من استهجان أفلاطونيّ، إنّه الوحيد – حدّ اليوم-، لم يجد إقامة له في تلك الحقول، فالممثل كما المخرج والكاتب والسينوغراف وغيرهم لهم الأركاح والشركات والهياكل التي من خلالها يترجمون حياتهم المسرحية، أمّا بالنسبة للناقد فلا فضاء له في عوالم هذا الفنّ وخرائطه، بشكل يكاد يكون كليّا، لذلك فهو كائن هامشيّ، يتمّ إقصاؤه من دائرة الاهتمامات الملحّة والضرورية التي يسعى إليها أصحاب هذا الفن في سياق المقاومة المسرحية بوصفها جاعلة من المسرح فنّا يجدّد آلياته في كل مرّة، يهدم ذاته ليتجدّد ويجدّد في منظوراته وتصوراته الجمالية والفكرية.
تسري مغالطة كبرى وعنيفة، وجدت نشاطها في ذلك الإدعاء القائل بتعدّد أفضية النشر الإلكترونية والورقية بوصفها وطنا لأولئك النقاد في نظر البعض، وعلى الأغلب هي الآن تقصيهم بشكل علني وسافر لأنّها تتنافى وخصوصيتهم، فهم ليسوا إعلاميين أو كتابا تحت الطلب، لذلك هي تفقدهم صفة النقد بقدر ما تكدّس نصوصهم مع نصوص أخرى مبتذلة ورديئة يكتبها الإعلاميون أو بعض من الأرهاط المنتسبين إلى الفعل المسرحي انتحالا. وعلى الأرجح أيضا: إنّ تلك الأفضية بتعدّدها وتنوعّها تبدو كما لو إنها أسواق تتكدس فيها نصوص متهافتة مثلها مثل البضاعة، فيختلط الجادّ بالتافه، والجيّد بالضعيف، ما يولّد فيما بعد صعوبة كبرى في فرز المهمّ والأهمّ من التافه والرديء: لقد جعلت تلك الأفضية من مهمّة النقد عاطلة عن العمل، وفسحت المجال للكيتش النقدي الذي بات يقدّم نفسه أيضا أطول الواقفين في حقول الكيتش المسرحي، حيث الابتذال ومولد عصر “الخردة الفنية”.
ما يحدث أيضا في الكرنفالات والمهرجانات، ينمّ هو الآخر عن مغالطة جديدة، وجدت نشاطها في اقتطاع مؤهّلات كبيرة لبعض النقاد وإلصاقها في نشرياتها، وعوض أن تكون تلك المجلات أو النشريات عبارة عن فضاء تقييمي ونقدي يلامس مواطن الضعف في الأعمال المسرحية المشاركة أو سياسيات المهرجانات القائمة، فقد تحوّلت إلى مثابة ورقات مهمتها لا تتعدّى حدود التوثيق لدورة من دوراتها أو هي لسان حال منظّم تلك الدورة وبوق دعاية لما يحدث، وأن يتواجد ناقد في تلك المساحة فعليه أن يخضع لتلك السياسات ويتحوّل إلى أحد أولئك الذي وصفهم أدورنو، أحد كبار مدرسة فرانكفورت، بـ”كلاب فلاسفة الثقافة”.
نحن لم نعد في حاجة إلى نقاد، هذه هي الحقيقة التي يقرّ بها راهن مسرحنا الآن، لقد ماتوا مثلما مات الإله المسيحي في عيون فيلسوف الديناميت، أمّا رائحة دمهم، فنحن نشتمّها هنا، في تلك الأفضية والنشريات التجارية أو الأيديولوجية. على نقيض من ذلك، صار على بعضهم أن ينجو من تلك المكيدة، لهذا نحن لا نقرأ لهم هنا في هذه الحقول التي تمّ تسميم كرومها المسرحية، بل من خلال كتبهم الأكاديمية، وهي ذات طابع نظري أكثر منه نقدي، لذلك هي الأخرى لا تعالج أعمالا مسرحية أو تشرحها أو تفكّكها، بقدر ما تتركها شريدة، دون أيّ حسّ حواري يصاحبها بغاية النقد والتجاوز، وبغاية تطويرها، و”هكذا، تمّ تقطيع أوصال الناقد من خلال قوتين متعاكستين: الميل إلى جعل النقد الأكاديمي عملية داخليّة تعنى بنفسها وتهمل الحكم والتقويم، والزّخم الذي اكتسبه النقد الصحافي والعام ليصبح فعّالية أكثر ديمقراطية وانتشارا، بحيث لا تُتْرَك بين أيدي الخبراء”(1).
ليس موت النّاقد حدثا مهمّا علينا مواكبته بإعلان عرس جنائزيّ له، فالفنّ المسرحي نفسه، اليوم، يشهد أزمات كبيرة، وأن نقرّ بعدم نهاية مجده، في سياق قد يتعارض مع ما ذهب إليه بنيامين بإعلانه أفول هالة الفنّ في عصر الإنتاج التقني (2)، وفي سياق قد يتعارض مع ما ذهب إليه أدورنو بدخول الفنّ عصر الصناعة وتخليه عن ماهيتّه الحقيقية والمتمثلة في كونه ذلك الفكر المغاير الذي من شأنه تحقيق عالم إنسانيّ تزول على إثره تناقضات الواقع القائم (3)، فهذا لأنّنا ندافع عن براءته من المسرحيين، مخرجين وكتابا وممثلين: هؤلاء هم أيضا يمثّلون خطرا على هذا الفن، وربّما لو نقرّ بفكرة النهايات التي سادت منذ فقدان الثقة في سرديّات المشروع الحداثيّ، فإنّه لن يكون ثمة قتلة غير هؤلاء، لأنّهم المسئول الأوّل عن تجديد آليات المقاومة المسرحية، لكن كيف يمكن تفسير موجة الانتحال والاستنساخ الذي ضربت المسرح كالطاعون؟ وكيف يمكن تفسير ذلك الانحدار الأيديولوجي الذي يجرفه الآن إلى واقعية جدانوف وابتذالها القائم على المباشراتية؟ وكيف يمكن تفسير تحوّل البعض إلى مجرّد متسوّل باحث عن الدعم؟ وكيف يمكن تفسير لهث هؤلاء وراء الإعلاميين بغاية الدعاية لأعمالهم؟ ربّما يمكن تبرئة البعض بالقول إنّه ثمّة مبررّات إنتاجية تدفع إلى ذلك؟ لكن أن يتحوّل ذلك إلى هدف بعينه، وأن يسقط الفنّ برمّته طريدة سهلة في قبضة سياسات التبضيع التجاريّة ومحافل الدعاية الاقتصادية، فيا لوطأة العزاء المسرحي، ويا لغيبة ذلك الناقد الذي مات! وإن هو عاد إلى الحياة المسرحية فبوصفه يشغّل الكراهية والحقد، وكأنّ مهمّته الآن لا تتعدّى تنشيط ثأر عظيم من تلك الأعمال.
عليه –الآن-، أن يكتب كي يحطّم تلك المسارح والأعمال السّائدة، و عليه أن يستغلّ كافة مهاراته الكتابية ومعارفه من أجل النجاح في تنشيط الكارثة؛ هكذا يتحوّل موته إلى موت مضاعف، وجماعيّ، إنّه الآن بلا فضاء، غير مرغوب فيه، لكن من حقّه الدفاع عن وجوده، وهو أيضا في معادلة تقول بفكرة النهايات، وليس لها غير أن تشرّع لثقافة السوق وحرب الإيديولوجيات، ولا مجال فيها إلى الكتابة الجماعية أو الحرّة، فليسحب قلمه هو الآخر، لكن عن ماذا سيكتب؟ عن مقالات الإعلاميين وقراءاتهم للفعل المسرحي والأعمال الإبداعية كي يردّ عليها بغاية فضح نزعتها التجاريّة وقحطها الفكريّ بعد أن استحالت لذّة التلقّي التي عبّر عنها رولان بارت بلذّة النصّ؟ عن غربته في حديقة المسرح لم توفّر له فضاء ما؟ عن ما يراه الآن من غدير فني؟
في كلّ الأحوال، هو الآن سيكتب بشكل فيه الكثير من المواجهة لا المقاومة، وهو الآن لا بدائل له غير فلاحة التخريب؟ ولكنّه وحيد، ونابتة، وغريب؛ فيا لهذا القربان المسكين، و المحارب العدمي !!
– إنّه لمن الحيف اليوم أن نقرأ لبعض النقّاد فنكتشف أنهم يهاجمون منجزا مسرحيا مّا، إنّهم على جهل واضح وبالغ الصفاقة بخلفيات ذلك العمل، هكذا يردّد أحد المسرحيين من المختصين في الإخراج أو الكتابة أو التمثيل.
لكن أحد النقاد من أولئك المتّهمين بالكراهيّة يمكنه الردّ بإجابة كهذه:
– لنتفق أوّلا ما إذا كان ذلك المنجز يمكن تصنيفه مسرحا أم هو يمثّل شيئا آخر.
سيجيب نفس المسرحي:
– ذلك عائد إلى التجريب، أو هو مسرح يتنزّل في حالة “ما بعد الحديث”، إنّه أقرب إلى الأشكال التعبيرية الجديدة.
سيضحك الناقد مستهترا هذه المرّة، ونظنّه على حقّ، وإلا كيف نفسّر احتفاء ذلك المسرحيّ، في المقابل، بمقال كتبه أحد الإعلاميين وحلّل من خلاله ذلك العرض المسرحيّ أرسطيّا، وهو الذي كان يتحدث عن منعطفات جمالية جديدة؟
يا لوطأة الضحك فعلا، إنّ الأمر سيبدو كما لو أنّه محض ثرثرة مسرحية لا طائل ولا جدوى منها، كما لا يخفي علينا تلك العلاقة المتوتّرة منذ قديم القديم بين المبدع والنّاقد، أو كأنّنا لازلنا شاخصين في المرايا الأفلاطونيّة، ونزجّ بعوالم الكتابة النّقديّة ضمن مدارين لا ثالث لهما: المديح أو الهجاء: ثمّة إذن ثقافة مسرحيّة قائمة على الاجتثاث والاستئصال، وثمّة ما يدعو الآن إلى البحث عن مدار ثالث تُوَجَّهُ فيه العلاقة بين النقّاد والمبدعين إلى معادلة مغايرة، ولا نعتقد أنّ عمليّة ايجادها يمكن أن توجد بمعزل عن عودة المسرح إلى حقوله الفلسفيّة والفكريّة وينابيعه الأنطولوجية، إذ لن تعود الحياة إلى النّاقد دون عودتها للفنّ برمّته، حينها فقط يمكن البحث عن ماهيّة جديدة له.
2- عن مهمّات الفلسفة: أو كيف يمكن التفكير فلسفيّا في المسرح
لنعترف أوّلا أنّ الأزمة شاملة، وليس ضحيّتها النّاقد فحسب، بل الفنّ المسرحي ككلّ، ولنعترف بالمكيدة التي نحن بصددها، ولنعترف أيضا بحقيقتنا المخجلة؛ إنّ سرّ هذه الأزمة ما هو إلا انعكاس لأزماتنا السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية ككلّ، ولنعترف أخيرا أنّ سرّ هذه الأزمة برمّتها هو عدم تفكيرنا بجديّة في المستقبل.
نحن الآن في منعطف فارق من تاريخنا: هنا ليس ثمّة غير تخصيب الأصوليات والنزاعات، لقد تحوّل كلّ شيء إلى كابوس، أمّا مستقبلنا كنوع بشريّ، فهو في قبضة حداثة فشلت في الايفاء بوعود السعادة وفي قبضة بيارق الله. نحن كمسرحيين ننتمي إلى الأولى، وعليه فنحن مُعَوْلَمون غصبا عنّا، ومثلما نسقط في جرف هذه العولمة المنادية بتخطي الإرهاب، فإنّنا ننسى أنّه صنيعتها هي الأخرى، فبعد انتفاء مشروعية بقائها منذ أن انعطف العقل التنويري إلى عقل أداتي ونفعيّ، عمدت إلى اختراع عدوّ تحاربه كي تهب نفسها شرعية الوجود، وهذا أمر لم يعد في حاجة إلى توضيح أو تأكيد منذ تمّ تفكيكه مع فلاسفة وكتاب كبار، من دريدا وهابرماس وفتحي المسكيني إلى جان بودريار وإدغار موران وسلافوي جيجيك…إلخ. هيا نتجاهل هذا الكلام، هيا نستمرّ أو نتوغّل أكثر في فكرتنا:
إنّ مهمتنا في خضمّ سياق كهذا، هي الإفصاح عن خلل هذه المعادلة وعبورها، لكن كيف؟ ربّ سؤال سيحيلنا مباشرة إلى إعادة قراءة تاريخ المسرح؛ أين هاجر الشعراء الكبار، أولئك الذين كتبوا غوائل الحياة، وأولئك الذين بإمكانهم إعادة الطاقة الترميزية للعالم؟ وأين هم أولئك الفلاسفة الذين كنّا نسير معهم في نفس النسق المسرحي؟
لتعد إلينا الفلسفة إذن، عليها أن تحشر نفسها وبقوّة في حقولنا المسرحية التي عمّرها اليباب، وعليها أن تعيد الشعراء إلى موطنهم المسرحيّ، لأنهم هم من يخيط جراحات العالم. ولنعترف مرّة أخرى، من باب التأكيد لا التكرار، إنّ موت الناقد ما هو إلا نتاج لتلك الوطأة التي وضعنا في حقولها بنيامين حيث انتهت هالة الفن، ودخل في طور الصناعة ما جعله بضاعة محض، وأفقده طاقته الترميزية، حتى أنّه تحوّل إلى ضرب من الأسلحة في قبضة الايديولوجيات. ولكنّ محفلا جنائزيّا كهذا الذي ندركه، لم يمنع نيتشه، فيلسوف الدّيناميت، ذات كتاب من إعلانه مولد التراجيديا كردّة فعل عنيفة وتجاوزية لفكرة النهايات، وهذا المحفل الجنائزي لم يمنع أيضا فيلسوف الجموع طوني نيغري من تنشيط “الرائع العملي” بضرورة أن تكون الحياة هي عينها الفنّ بما هو في قبضة الثوريين، ثم إنّ هذا المحفل الجنائزي بما هو ناتج عن أزمة واضطراب ما، لم يمنع قرينه القديم في أزمنة البربرية من مولد الفلاسفة الأخلاقيين الذين دعوا إلى انتظام الفعل المسرحي منذ أن تمّت عملية رفع الاحتفالات والصخب الباخوسي من الساحات العامة إلى القاعات، فكان ثمة فيما بعد أفلاطون وراء المحاورات السقراطية، وأرسطو الذي ترك أيقونته “فن الشعر”.
تبدو إذن فكرة التسليم بموت الناقد، فكرة متداعية بإطلاق، وحتى أنّ راهننا يشي بتلك الفكرة ويؤكدها، فهو لا يمكنه إخفاء حقيقتها المتمثّلة في كونها نتيجة واضحة لهيمنة فكرة أخرى أكثر وطأة وعنفا، ألا وهي فكرة النهايات، إنّ هيمنة هذا التصوّر ما هو إلا اعتراف علنيّ بالعجز عن استنطاق المستقبل الذي تسوده نزاعات الدمار العالمي وحرب الأصوليات وانعطاف الفكر التنويري إلى فكر نفعي وأداتي في مقابل فكر ظلامي ولد كردة فعل بافلوفية، ومن ثمّ انعكاس هذا “القحط الأنطولوجي” – بعبارة نيغري- على الفنون بشكل عام والمسرح بشكل خاص.
ماذا بوسع الفيلسوف أن يقدّم الآن: إنّه ذلك الذي يحمل المعول كي يفتح من خلاله ثغرات ما في معادلة هذا الراهن، منها نعبر إلى المستقبل: الفيلسوف هو الذي يملأ العالم بالمعنى ومن ثمّ بَذْرُ الإنسان في التربة المناسبة.
أيّ دور إذن يمكن أن يلعبه في الحقل المسرحي؟ إنّه ذلك الاعتراض العنيف والمتهكم ضدّ السائد، حيث إعادة تربية العقول بجعلها نقدية لا نفعية، بمعنى أن تكون عقولا حرّة، تجد في جيل دولوز حديقة خصبة نحو ابتكار المفاهيم ونحتها وإبداعها (4)، هكذا يتخلّص المسرحيّ من عقم المعنى السّائد وعماء تأويل الواقع والعالم، وتجد في ابن باجة والمسكيني على عكس أفلاطون، معنى أن تكون عقولا نابتة، هكذا يصبح المسرحيّ أبعد من سراديب الفكر، وفوق عصره، ليس من منظور يقول بانزياحه عن القضايا الموجودة، بل من خلال استيعابه طاقة فذّة تخوّل له جرّ عصره إلى حقبة جديدة، خارج نزاعات اللاانسانيّ.
ما بوسع الفلسفة أن تقدّمه للمسرحيّ الآن، هو أن تعلّمه كيف يتفطّن إلى وضاعة الوجود البشريّ القائم حاليّا، وكيف يمكن أن يتخطّى ذلك الكوجيطو القائل بأنّ “كلّا منّا يسطّر للآخر حدّه الميتافيزيقيّ الفظيع، ويبني له بوّابة على الموت” (5)، هكذا ينجو من سياسات القتل، ومن سرديّة النهايات، بوضع أعماله ضمن أفق انسانيّ وكونيّ يحاور المستحيل، بمعنى تأثيث البيت المستقبليّ للعالم، خارج نزعة العقل الوضعيّ ونزعة العقل السّلفيّ الماضويّ، بوصفهما جعلا من امكانيّة الحياة أمرا يكاد يكون مستحيلا، إن لم نقل مجرّد ثرثرة ميتافيزيقية أمام حجم الكوارث التي تمرّ بها شعوبنا حاليّا، وتعدّد بذور الحروب في تربة الإنسانيّة.
قد يبدو لا معنى لهذا الحديث في ضوء الاشكالية القائلة بموت النّاقد وارتباطه العضوي بأفول الفنّ، ولكن علينا أن ننتبه إلى أنّ التفكير الفلسفيّ في الفنّ المسرحيّ، لا يمثّل سلطة للمراقبة وللمعاقبة بتعبير فوكو، أو هو يشرّع لذهنيّة تحريم جديد إذا ما نشّطنا عبارة صادق جلال العظم، وإنّما هي عمليّة تدخل في إطار إعادة فلاحة الفكر المسرحيّ ككلّ، كي يعيد التساؤل لا عن الحالة الاجتماعية الظالمة وما إذا كان عليه أن يعتني بها أو يترك تلك المهمّة للسياسيين والمدافع، بل عن أفقه المستقبليّ، في ضوء جراحات يخدش من خلالها حدود المعادلة التي تمّ سبيه في تخومها علّه يرتقي إلى معادلة جديدة، تُنْتِجُ أعمالا عظيمة في حجم كارثة الرّاهن ومغايرة لهذه الأعمال السّائدة التي كرّست مشروعيّة تأبيد القول بنهاية الفنّ، تلك التي تفوح من اهتماماتها “رائحة الانسان الزّائل المادّي (…) الإنسان الجيفة”، و”رائحة التدهور والصديد”(6)، وتكرّس لمسرح دون خطر، ودون قدرة على اقتلاع الحبّ من مخالب الكارثة.
أن ينجح المسرحيّ، الذي يصاحبه الفيلسوف، في استنطاق سردية جديدة للنّوع البشريّ، فمعناه إمكانية جديدة للحياة تبشّر بمولد انسان ما بعد الخير والشرّ، وما بعد ميتافيزيقي، لا يثق إطلاقا في معادلة الراهن، فالحداثة نفسها انسحبت بدورها إلى حديقة اللاهوت، وما انتسابه إليها في ضوء سياسات التصدّي للثقافة الظلامية ما هو إلا سقوط في البهرج الاستيطقي والليبرالي الذي ولّدته أسواق الحداثة نفسها، وما هو إلا سقوط في أودية الأصولية الدّهماء: إنّ المسرحيّ الأخير هو ذلك يهدم كلّ هذه الفزّاعات البشريّة، وأن يقدّم لنا الآن، من خلال هذا التصور، رؤيته إزاء العالم مسرحيّا، فمعناه ثمّة إمكانية جدّية لمولد النّاقد الأخير، ذلك الكائن الرّؤيويّ، لا ذلك المحارب البائس والعدميّ، ولا ذلك الصحافيّ المأجور.
3- مولد النّاقد الأخير: رؤيوي، مفرد لكن بصيغة الجمع
نتأكّد، إذن، أنّه لا يمكن الحديث عن الناقد الأخير في ضوء موت الفن وانهيار القيم وفراغ العالم من المعنى وارتهان المنجز المسرحي إلى ما هو ليبرالي وتجاري تتحكم فيه بورصات الأسواق والكرنفالات والمهرجانات المسرحية، إنّ هذا الناقد لا يكتب ولن يكتب على الإطلاق ما دامت حالة الراهن على هذا المستوى، وهو ليس ذلك الكائن الخارق الذي سيعطينا وَحْيًا، بمعنى: أن يكتب الحكمة المسرحية لنفسه ويريد أن يجرّنا إليها كأتباع له. كلّا، فهو ليس من سلالة الآلهة، ولا يروق له أن يكون كذلك: إنّه ااببن الشرعي للعقول الحرّة، وسليل النّوابت، ينتظر مثلنا تغييرا عنيفا على المستوى العالمي، وتغييرا عنيفا على المستوى المسرحي، حتى ما إذا ما كتب حينها يكون قد أفصح عن حالة عشقيّة بيننا والمسرح، وبين المسرح والحياة، وبين الحياة والعالم. هذا الناقد هو تتويج لمسار ألم المسرحيين العظيم، وألم حياتنا العنيف، وألم مجتمعاتنا التي تخيّم فوقها بيارق القيامة، إنّه صدى لذلك الإله الأجمل، ديونيزوس، في هذا العالم، وبما أنّه يعسر تعريفه الآن في أجهزة مفهومية دقيقة، فإنّ مولده في المستقبل سيكون مقترنا بعودة الدهشة إلى المسرح.
إنّ هذه الولادة، ليس من مهامّها مقارعة سرديّة النهايات، بقدر ما هي تمثّل ضدّها النّوعي في سبيل استنطاق المستقبل، إذ معها تشطب الحدود القائمة بين المبدع المسرحيّ والنّاقد والفيلسوف، وتحيلنا إلى أفق “ما بعديّ” تتلاشى فيه تلك الحدود بين مختلف المجالات المعرفيّة، حينها يصبح متاحا الاعلان عن مولد النّاقد الأخير، الرّؤيويّ الذي لا يمكن تصنيفه كناقد كلاسيكيّ، أو كاتب، أو فيلسوف، أو مخرج، أو دراماتورج، أو شاعر، بل هو ذلك المفكّر الذي يكون كلّ هؤلاء وقد اجتمعوا في صورة نبيّ يشعرنا بجماليّة الوجود، وبإمكانية عودة النّقاء إلى عالمنا، كما يمنحنا فرصة للتكلّم بشكل جماعيّ إزاء عمل فنّي واحد، إذ ليس ثمّة أسطورة تنتهي بثبات الأصل، بقدر ما ثمّة حقل تناصيّ دائما، وتناسج تتعالق فيه أطراف متباعدة ومتعالقة بشكل مكثّف، وعليه يمكن اعتبار موت المبدع المسرحيّ أو الناقد ما هو إلا حالة ضرورية حتى تتمّ عودتهما إلى الحياة بشكل مغاير يقول بالكفّ عن جعل الفنّ المسرحيّ مجرّد “حيوان” أصوليّ أو حداثيّ، وبشكل يكون فيه كلّا منهما مرآة الآخر، وبوصفهما أيضا مرايا العالم وجمرة العصر وحرّاس المستقبل.
4- شــــــأن آخـــــــــــــــر
والآن، لننعطف إلى شأن آخر، هل صحيح تخلّى المسرح عن الرّوح الديونيزية للشّعراء؟ هل صحيح أنّ هذا الفنّ طردهم من دائرة اهتمامه؟ وإذا كان ضروريّاً التّسليم بهجرة المسرح من النّص الأدبيّ إلى اختراع لغته الخاصّة – تلك الّتي تعقد ضربا من الإقامة في الأداء بدل التّمثيل وفي التّشظي بدل الخرافة وفي الإدلاء بحالات بدل الإدلاء بوضعيات وإبراز مواقف بدل إجراء تحاليل، فهل ظلّ محافظا على سرديّة الطّقس الأوّل أين نلتقط صدى الديثرامب أو أين نقرّ على لسان جيل دولوز “إنّ الشّخصيّة التّراجيديّة الوحيدة هي ديونيزوس”؟ علينا الاعتراف بحدث الطّلاق بين المسرح والشّعر منذ نهاية التّمثّل الأسطوريّ للعالم فلم يعد ثمّة ذلك التّراجيديّ الّذي يسرد كينونة النّوع البشري، أمّا أن ننتبه الآن ونحن نعيش في عصر الكارثة فليس ثمّة شعراء حقيقيون يقيمون في قرى الإنسانيّة، وليس ثمّة ذلك الكاتب أو الشّاعر النّبيّ الّذي يفصح عن نصّ مسرحيّ في حجم الدّمار الذّي نعيشه، وهذا ما أقرّت به العديد من الدّراسات والبحوث النّقديّة في سياقات متنوّعة ومختلفة ربّما من أهمّها تلك المقالة الّتي أوردها المسكيني في كتابه “الهجرة إلى الإنسانيّة” وحملت عنوان “الشّعراء يحرسون هشاشة العالم”. أن يولد هذا الشّاعر فمهمّته ليست إنتاج خطاب لغويّ ينمّ عن قدرة فذّة في الكتابة، بل في إمكانيّة تقول بأنّ هذه الكتابة عينها تدفع بالمسرح كي ينعطف إلى ما هو سحريّ وطقوسيّ وروحيّ، بمعنى إعادة تنشيط بعده الدينيّ القديم في ثوب فرجة العرض المسرحي الحديث.
كيف يمكن إذن مسرحة العنف الكونيّ بترجمته لغويّا ثمّ زراعته فيما بعد داخل أوصال اللّحم المسرحيّ؟ وإذا ما اعتبرنا أنّ رهانا كهذا يبدو مستحيلا، فهل علينا التّسليم بنهاية ديونيزوس بوصفه الرّمز الأسطوريّ الأوّل في ذاكرة البشريّة حول مسألة الانبعاث والتّجدّد؟ قال المسكيني في كتابه “الأنوار والحريّة”: “الشّاعر هو البديل المتعالي للعصور الحديثة عن النّبيّ”. ربّ شذرة ستحرّضنا على الفور للبحث عن مكانة المسرحيّ في هذه العصور الحديثة: ألا يبدو في حالة كهذه صيغة عليا أو بنفس العبارة الّتي استعملها المسكيني (البديل المتعالي) عن ديونيزوس؟ إنّ الشّاعر على هذا النّحو هو ذلك النّبيّ الّذي يقدّم تعاليم الإله ديونيزوس إلى المسرحيين حتّى يمكنهم الحلول في لحمه.
سيمكن للمسرح في حالة كهذه طرد الشّعراء والكتّاب والكلمات، من حيث مهمّاتهم القديمة، لأنّه هو الآخر – بعبارة أنتونان آرتو-، “كالكلمة، في حاجة إلى أن يكون حرّا”. وعلى الأغلب، إنّ حريّته تلك لا تمثّل قطيعة مع النّصوص بقدر ما هي تمثّل ضرباً من تحويل مصائرها ركحيّاً. هكذا يمكن القول إنّ الشّعر هو مخزن الطّاقة المقدّسة والأسطوريّة في حياتنا، تلك الّتي يتعيّن على المسرح المراهنة عليها في موضوعاته، إذ بقدر ما تعيد إليه التّوهّج والكثافة، تهبه إمكانيّة التّفكير في المستقبل، كما توفّر له عدم الحاجة إلى مواجهة الكارثة، لأنّه بهذا الشّكل سيتخطّاها لا نقدا فحسب، بل تجاوزا أيضا.
نعم، يجب أن نكفّ عن ذلك الفهم السّاذج الّذي يدعو إلى طرد الشّعراء والكتاب من المسرح، إذ يتعلّق الأمر بتغيير مصير كلماتهم لا شطبها من الوجود المسرحيّ، ها هو أنتونان آرتو يعلن بالقول في كتابه “المسرح وقرينه”: “لا يتعلّق الأمر بحذف الكلمة على المسرح، بل بحملها على تغيير مصيرها”. إنّ تغيير مصير الكلمات لهو ضرب من استحضار الرّوح الديونيزوسيّة في المسرح وفق ما تقتضيه حاجة هذا الأخير في ضوء المنعطفات الجماليّة، أين تسلخ اللّغة عن خطابها السّائد بما هي كتابة قائمة على المحو وعلى أنقاض كتابات أخرى سابقة: إنّها تمثّل حضوراً ميتانصيّاً قوياً لا يخلو من آثار قديمة، ستبدو كما لو أنّها كتابة حول الشّتّات الديونيزوسي حيث لا نعرف إن كنّا سنتقدّم إلى المستقبل أو نتراجع القهقرى إلى الماضي، وهذه إحدى سمات عيشنا في العصور ما بعد حداثيّة، تلك الّتي تعكس لحظة رعبنا الكوني. ندرك أخيرا أنّه لا ثمّة لقاء بين الشّعراء والمسرحيين إلاّ في شتات ذلك الإله الغابر، هذا الّذي يحضر الآن على نحو ما بعدي في خطاب ما بعد الحداثة، هذا الّذي تمحى فيه الحدود بين الأجناس الفنيّة جميعها.
كلّ اختصاص متقوقع على أناه هو اختصاص ميّت، سلفيّ بالعبارة الدينية، لا يبشّر إلّا بفكرة الاستئصال.
___________________
1- رونان ماكدونالد: “موت النّاقد”، ترجمة فخري صالح، المركز القومي للترجمة، دار العين للنشر، ط1، 2014، ص 17.
2- – بنيامين: “العمل الفنّي في عصر الاستنساخ الآلي”، ترجمة سيزا قاسم، مجلّة شهادات وقضايا، العدد 2، 1991، ص 239.
3- Adorno: « La Théorie Esthétique », Trad, Marc Jiménez, Les Editions klincksiek, Paris, 1974, P 29.
4- بالشيخ (محمد): “بناء المفاهيم وإعادة بناءها”، عالم الفكر، مجلد 41، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2012، ص 45.
5- فتحي المسكينيّ: “فلسفة النوابت”، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1997، ص 24.
6- أنتونان آرتو:”المسرح وقرينه”، ترجمة سامية أسعد، دار النهضة العربية، ص 34.
حاتم التليلي محمودي.